معضلتنا مع الناقد المسرحي المنفجع
يحاول المنفجعون والمتلبسون عباءة النقد أن يسيّروا صناعة كاملة بحسب لحظتهم المعرفية. يتعرَّف إلى لون جديد ويطالب الصناعة بأن تنصاع لفجعته.

من سمات المسرح لدينا «جديته»، والمقصود بذلك ابتعاده عن الإسفاف -كلمة يطيب لهم استخدامها دائمًا- وأيضًا عدم اختزال الكوميديا في المفهوم الضيق للسخرية المباشرة. وغالبًا ما يكون للمسرحيات طابع غرائبي وغير مفهوم وغارق في الرمزيات، بل قد يشعر المتلقي أحيانًا أنه أمام عرض مفكك.
تساءلتُ بعد مشاهدتي إحدى تلك المسرحيات عن سبب وجود مثل هذه الأعمال لدينا. فالمسرحية كانت تدور حول جندي في معسكر حرب يحاول الهرب، ولم نكن نعلم عن الطبيعة الجغرافية للمكان أو الهوية الثقافية أو الأبعاد السياسية للحرب، بل لم نرتبط بالشخصيات التي كانت تتحدث بلغة مُقعَّرة لا تشبهنا في شيء. ثم تساءلت عن سبب رواج مثل هذه المسرحيات، إن كانت رائجة فعلًا، وعن سبب استمراريتها. لكن بعد فترة، في محفل ثقافي يخص المسرح، أظن أنني فهمت الأسباب.
في تلك الأمسية، أمسك «المايك» أحد نجوم المسرح وأبرز كتّابه ونقّاده، وبدأ تقريع الممثلين على عدم اقترابهم من الجمهور عبر طرحهم النخبوي المعقّد، وأن ذلك أحد أسباب عزوف الجمهور عن الحضور إلى المسرح. وفي الوقت نفسه نوَّه «منفجعًا» إلى أنه عاد للتو من مهرجان للمسرح في دولة عربية فازت بجوائزه مسرحيات كوميدية!
مكمن تدوينتي هنا هو ما أسميه «الفجعة الثقافية»؛ تلك الحالة التي تصيبنا عندما نقرأ ما ننبهر به، ونصبح فجأة مؤيدين و«مطبلين» بل حتى «مبلطجين» له، وتجتاحنا مشاعر مندفعة لإبداء هذه الآراء وفرضها على الجميع. قد تكون هذه الآراء طبيعية وصحية في عمر مبكر، حيث يكون المرء عرضة لـ«الانفجاع» بكل ما يجدُّ عليه من قراءات، ولكن من غير الصحي ممن يطلق على نفسه لقب «ناقد» أن يكون سلوكه المعرفي كهذا، بخاصة إذا كان ممن يؤثِّر في الحركة الثقافية.
فأحد أسباب وجود هذا المسرح الغريب لمدة طويلة هو أن ذاك الناقد نفسه كان يعيش فجعة ثقافية أخرى في فترة سابقة كان مهووسًا فيها بالعمق والرمزيات والنخبوية ومسرح المهرجانات في مقابل المسرح التجاري، ولذلك جعل الممثلين يؤدّون شتى أنواع الغرائبيات. فيومًا يرتدون السراويل على رؤوسهم، ويومًا يحملون الشموع بأفواههم، ويومًا آخر يُعلَّقون مقلوبين على الجدران، وكل ذلك بدعوى الرمزية والعمق.
أما اليوم فهو يعيش «فجعة» أخرى، إذ اكتشف للتو كوميديا الموقف والمفارقة والتهكّم، وأن الكوميديا جادة كما «المسرح النخبوي»، وأن بإمكانها الظفر بالجوائز. وغدًا سيُفجع بشيء آخر، سيكتشف مثلًا أن «الجنر» (Genre) ما هو إلا تصنيف سائل لا وجود جوهريًّا له، وأن الرعب والدراما والكوميديا بإمكانها أن توجد في مسرحية واحدة أو حتى شخصية واحدة. وبعد ذلك قد يُفجع بشيء آخر مجددًا، ربما سيكتشف أن المسرح والشعر والموسيقا شيء واحد، وهكذا…
يحاول هؤلاء «المنفجعون» والمتلبسون عباءة النقد أن يسيّروا صناعة كاملة بحسب لحظتهم المعرفية أو المتأخرة. يتعرَّف إلى لون جديد أو فكرة جديدة ويطالب الصناعة كلها بأن تنصاع لـ«فجعته»، والمشكلة حين يصدّق المشتغلون بالصناعة ويتأثرون، ومن ثم يمتثلون للحظته المعرفية.
الأمر ليس حكرًا على المسرح، بل هو مجرد مثال. جميعنا نعرف ذلك الصديق الذي يتغير كل شهر. فجأة أطل علينا بليبراليته ثم أصبح ماركسيًّا وبعدها اكتشف الأناركية ثم الرواقية.. وبعد كل تغيير يكون حادًّا جدًّا ومندفعًا في الدفاع عن أفكاره الجديدة التي تبنّاها للتو، ويحاول أن يجعل لحظته المعرفية هي اللحظة التاريخية للمشهد الثقافي بأسره.
أظن مما يمكن أن يسهم في التخفيف من هذه الحدة أن يعتقد القارئ والمهتم بالشأن الثقافي أنه ليس بمسؤول عن قيادة الأمة أو الجماعة، ومن ثم الاقتناع بأن الاشتغال الثقافي أبعد وأشدّ تعقيدًا من مجرد الانشطار بين ثنائية الصواب والخطأ. الاشتغال الثقافي يعني في المقام الأول أن نفهم ما نقرأ ونتلقى، وأن نطرح الأسئلة لنفهم، وأن نناقش لنفهم، وأن كل ما نقوم به في هذا الشأن هو أن نفهم، وأن أسمى معرفة تصل إليها هي أن تفهم، ومن ثم قد تتخذ موقفًا وقد لا تفعَل!
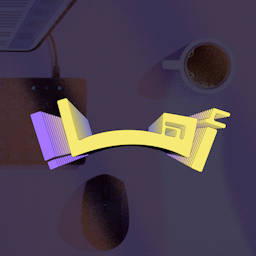 نشرة أها!نشرة يومية تصاحب كوب قهوتك الصباحي. تغنيك عن التصفّح العشوائي لشبكات التواصل، وتختار لك من عوالم الإنترنت؛ لتبقيك قريبًا من المستجدات، بعيدًا عن جوالك بقية اليوم.
نشرة أها!نشرة يومية تصاحب كوب قهوتك الصباحي. تغنيك عن التصفّح العشوائي لشبكات التواصل، وتختار لك من عوالم الإنترنت؛ لتبقيك قريبًا من المستجدات، بعيدًا عن جوالك بقية اليوم.